استبدال دم كلب بحليب معزة ودم مريضة بحليب امرأة!
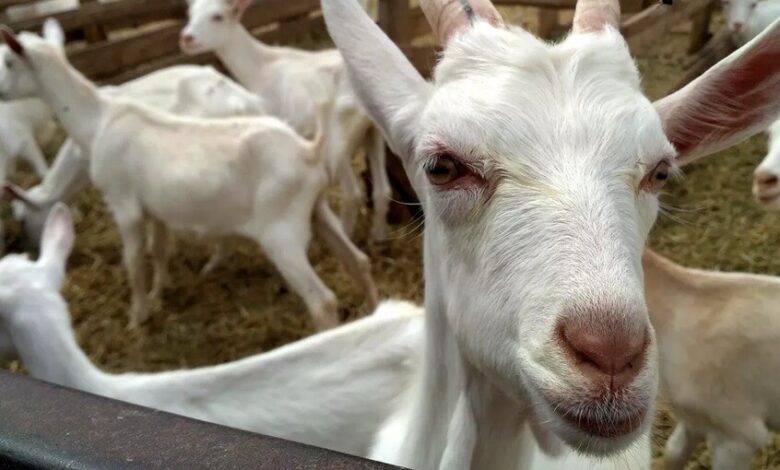
روافدنيوز/ متابعة
في العشرين من نوفمبر عام 1979، قبل ستة وأربعين عاماً، شهد العالم نقلة نوعية في تاريخ الطب، عندما نُقل لأول مرة “دم اصطناعي” مكون من مركبات الكربون المشبعة بالفلور إلى جسد إنسان.
كانت تلك اللحظة تتويجا لمسيرة طويلة من المحاولات الحثيثة لتحضير مادة تقوم بالوظائف الحيوية للدم، لكنها لم تكن النهاية، بل مجرد محطة انطلاق نحو آفاق أرحب. ذلك الدم البدائي لم يكن مثاليا، إذ لم ينجح سوى في إطالة حياة المريض لبضع ساعات فقط قبل أن يحتاج إلى نقل دم حقيقي من متبرع، كما تسبب في أضرار جسيمة للكلى وأدى إلى سكتات دماغية لدى بعض الحالات. حتى يومنا هذا، لا يزال الدم البشري المتبرع به هو الخيار الوحيد الموثوق في الممارسات الطبية، دون وجود بديل كامل يحاكي تعقيداته ووظائفه.
الدم ليس مجرد سائل أحمر يجري في العروق، بل هو عالم معقد من البروتينات والأملاح والصفائح الدموية والكريات البيضاء والحمراء، يشبه شبكة طرق سريعة فائقة الدقة. يقوم بنقل الأكسجين والغذاء إلى الخلايا، ويخلصها من النفايات، وينقل الهرمونات والأجسام المضادة، ويتجلط تلقائيا ليمنع النزيف عند الإصابة. وحتى الهيموغلوبين، ذلك الجزيء السحري داخل كريات الدم الحمراء، ليس حكرا على البشر، بل نجده منتشرا في مملكة الحيوان بأكملها، من السحالي البسيطة إلى الطفيليات المعوية.
تكمن أهمية الدم الاصطناعي في الحالات الطارئة التي يتعذر فيها الوصول إلى الدم البشري، مثل البعثات الاستكشافية في المحيطات والصحاري، أو أثناء الكوارث الطبيعية، أو في المناطق النائية التي تفتقر إلى بنوك الدم. كما أن عمليات نقل الدم ليست مقتصرة على الحوادث الخطيرة، بل تُستخدم يوميا في غرف العمليات، وعلاج السرطان، والتعافي من الإصابات، وحالات النزيف بعد الولادة. والأهم من ذلك، أن الدم الاصطناعي قد يتفوق نظريا على دم المتبرعين، فهو خالٍ من مسببات الأمراض التي قد تنتقل عبر الدم، مثل الهربس والفيروس المضخم للخلايا وفيروس الورم الحليمي، والتي قد لا تكتشفها الفحوصات الدورية إذا كان المتبرع في المراحل المبكرة من العدوى. إضافة إلى ذلك، فإن دم المتبرعين له عمر افتراضي لا يتجاوز 42 يوما، ولا يتوافق مع جميع الفصائل الدمية الأربع المعروفة، بينما يمكن نظريا تطوير دم اصطناعي عالمي صالح للتخزين لسنوات.
تعود المحاولات الأولى لإيجاد بديل للدم إلى عام 1660، بالتزامن مع أولى تجارب نقل الدم في التاريخ. فقد حاول الطبيب البريطاني ريتشارد لور نقل الدم من كلب إلى آخر باستخدام ريشة طائر، ونجح في إنقاذ الحيوان. بعد سبع سنوات، قام الطبيب الفرنسي جان بابتيست دينيس بنقل دم خروف إلى مريض بشري، كما توضح النقوش التاريخية التي وصلت إلينا من تلك الحقبة.
لم يتوقف دينيس عند هذا الحد، بل نقل لاحقا دم غزال إلى كاهن يدعى آرثر كوجا، نجا بعده، لكن أعراض الخرف التي كانوا يأملون في علاجها لم تختفِ. بعد قرن من الزمان، في عام 1795، أجرى طبيب فيلادلفيا الشهير فيليب سينج فيسيك أول عملية نقل دم بين البشر، نعرف عنها من إشارة عابرة في الأرشيف. وبعد عقدين، أنقذت أم من الموت بنقل دم من زوجها باستخدام محقنة بدائية.
لم يتوقف البحث عن بديل للدم عند حدود نقل الدم البشري أو الحيواني، بل تجاوزها إلى تجارب غريبة وخطيرة. ففي عام 1873، قام الطبيب جوزيف هاو في نيويورك بحقن مريض مصاب بالسل بـ 44 مليلترا من حليب الماعز، ما أدى إلى وفاته. لكن الطبيب واصل تجاربه على الكلاب، حيث استبدل دماءها بالكامل بحليب الماعز، ولقيت جميعها حتفها. لم يثنه ذلك عن محاولة استخدام حليب البشر، حيث قام في عام 1880 بنقل 60 مليلترا من حليب امرأة إلى مريضة أمام الملأ، لتتوقف عن التنفس بعد 30 مليلترا. لحسن الحظ جرى إنقاذها بحقنها بالمورفين والويسكي! وبعد هذه الحادثة، اضطروا للاعتراف بأن الحليب، رغم فوائده، لا يمت للدم بصلة.
في منعطف آخر، حاول العلماء استخدام دم الجثث، الذي لا يتجلط لخلوه من بروتين الفيبرينوجين. في عام 1928، قام الجراح فلاديمير شاموف بأول نقل لدم جثة إلى شخص حي. لكن هذه الممارسة لم تنتشر بسبب المشاكل الأخلاقية والقانونية المرتبطة بها. كانت أكثر المحاولات نجاحا تلك التي اعتمدت على الهيموجلوبين، حيث قام العلماء بتغليفه بطريقة خاصة تمكنه من حمل الأكسجين. في ثلاثينيات القرن الماضي، استبدل الباحثون دماء القطط تماما بمحلول الهيموجلوبين، لكنها عانت من فشل كلوي. وفي عام 1949، كرروا التجربة على البشر، وعانى خمسة من أصل أربعة عشر مريضا من أضرار بالغة في الكلى.
شكلت مركبات الكربون المشبعة بالفلور نقلة نوعية في هذا المجال. المثير للدهشة أن هذه المواد تستخدم عادة في صناعة الطلاءات والمنتجات المقاومة للحرارة والزيوت. في عام 1966، اكتشف عالم الكيمياء الحيوية ليلاند كلارك أن هذه المركبات يمكنها حمل الأكسجين، وإن لم تكن بنفس كفاءة الهيموجلوبين.
تطورت الأبحاث حتى تم اختبار أول بديل دم من هذه المركبات، “فلوسول دا 20″، على مرضى رفضوا نقل الدم لأسباب دينية. لكن التجارب السريرية في السبعينيات والثمانينيات كشفت عن آثار جانبية خطيرة، بما في ذلك زيادة خطر السكتة الدماغية ونقص الصفائح الدموية. رغم ذلك، جُرّب الدواء على أكثر من 40,000 شخص بين عامي 1989 -1992، قبل أن يتوقف إنتاجه بسبب صعوبات التخزين والتكلفة العالية.
في الوقت الحالي اتجهت الأبحاث نحو تطوير بدائل لكل وظيفة من وظائف الدم على حدة. باستخدام تقنية النانو، تمكن العالمان ديبانجان بان وفيليب سبينيلا من تحضير “إريثرومر”، وهو دواء مكون من خلايا دم اصطناعية على شكل دونات، تحتوي على جيوب نانوية من الهيموجلوبين. يمكن تجفيف هذا المستحضر وتخزينه في درجة حرارة الغرفة لفترات طويلة، ثم إعادة تنشيطه بالماء عند الحاجة، وهو متوافق مع جميع فصائل الدم. لكنه لا يزال يصلح لبضع ساعات فقط، مؤقتا حتى يتمكن المريض من الوصول إلى المستشفى لتلقي الدم الحقيقي.
تعمل أيضا مختبرات أخرى على تطوير بدائل للصفائح الدموية، مثل فريق الكيميائي إيرين لافيك في جامعة ماريلاند، الذي يصمم هياكل نانوية بوليمرية تساعد الصفائح الدموية الطبيعية على التكتل بسرعة أكبر، وفريق المهندس الحيوي آشلي براون في جامعة ولاية كارولينا الشمالية، الذي يطور جسيمات دقيقة تعزز تخثر الدم.
تبقى المعضلة الكبرى هي كيفية دمج هذه البدائل المتخصصة في سائل واحد يحاكي دم الإنسان بكل تعقيداته. قد نكون على بعد سنوات من تحقيق هذا الحلم.
يوما بعد آخر تقترب المختبرات من حل أجزاء من هذه الأحجية المعقدة. حين يتحقق الهدف، سنتمكن من تخزين دم اصطناعي رخيص وآمن وشامل، لا ينقل الأمراض، ولا يفقد صلاحيته، ولا يعرف حدودا بين فصائل الدم المختلفة. عندها، سنشهد نهاية عصر الاعتماد الكامل على المتبرعين البشريين، وبداية حقبة جديدة في تاريخ الطب، تكون فيها حياة الملايين بمأمن من شح الموارد واختلاف الفصائل وضيق الوقت./انتهى




